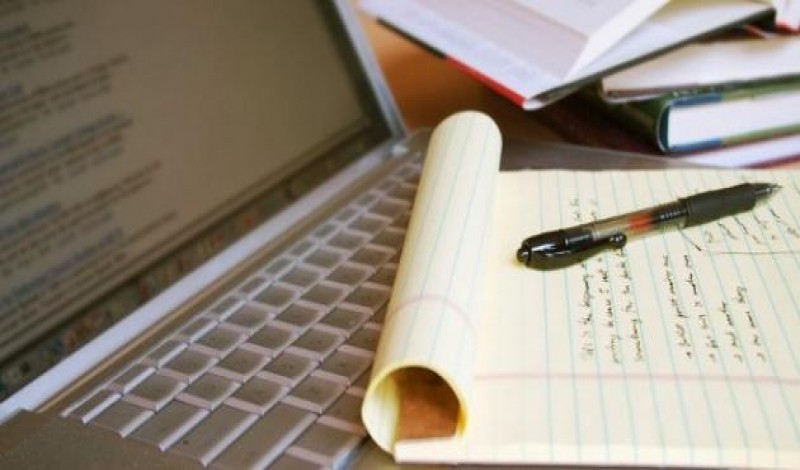لماذا ألغت إيران معاهدة عام 1937م؟
في 17/تموز/يوليو 1968م عاد حزب البعث العربي الاشتراكي لتسلم الحكم في العراق بآفاق واعدة ووعي ونضج عاليين، مستفيدا من تجربة حكمه عام 1963م وما رافقها من اخفاقات، ووضع الحزب الخطط الكفيلة لإنجاز خطة تنمية اقتصادية توظف الطاقات البشرية، في استثمار الموارد الطبيعية التي يمتلكها البلد، وخاصة استغلال الثروة النفطية في تسريع وتائر النمو الاقتصادي، وذلك من خلال تفعيل دور شركة النفط الوطنية العراقية، واستثمار حقل المشراق للكبريت، وكذلك وضع الخطط لاستغلال حقل عكاشات للفوسفات، وإقامة الصناعات التي تعتمد على هذه الثروات الوطنية الاستراتيجية، كما أعطى اهتماما استثنائيا للقطاع الزراعي باستصلاح التربة وإقامة المشاريع الكبرى للري والبزل، واستخدام الاساليب العلمية الحديثة في الزراعة من ري وتسميد ومكافحة الآفات الزراعية، ورفعت قيادة الثورة شعار الزراعة نفط دائم، لما للزراعة من دور كبير في توفير الغذاء للفرد العراقي وتوفير فرص العمل لحوالي 40 بالمئة من العراقيين، وتعزيز الأمن الوطني الغذائي، وفي المجال السياسي سعت قيادة العراق إلى تأكيد مبدأين أساسيين:
أ – على المستوى الداخلي حرصت قيادة العراق في عهده الجديد، على إقامة علاقات تحالفية مع سائر القوى الوطنية والقومية التقدمية في البلاد، والتي عاشت مرحلة احتراب سياسي طويل، إيمانا منها بأن العمل الجبهوي، هو الطريق الأسلم لعلاقات تحالفية بين قوى تلتقي على أهداف مشتركة أو متقاربة، وصولا إلى إيجاد حل شامل للقضية الكردية، التي طال أمدها كثيرا واستنزفت العراق ماديا وبشريا، وجعلته عرضة لتدخلات خارجية إقليمية ودولية، وكذلك حل مشكلة الديمقراطية في البلاد، ودراسة المقترحات الخاصة بممارسة العمل السياسي بحرية كاملة للأحزاب الوطنية، وإطلاق حرية العمل النقابي وحرية الصحافة والإعلام، والدخول في حوار جاد مع القوى الوطنية، لإقامة جبهة عريضة تضم الأحزاب السياسية في العراق، من أجل تجاوز سلبيات الماضي وفتح صفحة جديدة مع الجميع، وبالفعل تكللت جهود الحزب بالنجاح في أكثر من موضع لولا الموروث السلبي القديم لتلك الأحزاب، مثل الحزب الشيوعي والأحزاب الكردية، التي كانت تنظر إلى الخطوات التي تتفق عليها مع الحزب، على أنها استراحات محارب يريد استرداد الأنفاس لاستئناف معركته.
ب – على المستوى الخارجي عمل العراق على تأكيد هويته المستقلة في علاقاته مع مختلف دول العالم، وربط هذا الخيار بمدى الاقتراب أو الابتعاد عن قضايا الأمة العربية، وخاصة الموقف من القضية الفلسطينية، وكذلك مدى انفتاح الدول على حق العراق في إقامة دولته الحديثة، واستثمار ثرواته الوطنية المتنوعة، لقد كانت سياسة العراق النفطية بعد 17 تموز 1968م، مثار غضب من الدول المالكة لرأسمال الشركات الاحتكارية العاملة فيه، منذ اكتشاف النفط في العراق في النصف الثاني من عشرينات القرن الماضي، كما أن طرح ملفات الثروات الأخرى كالكبريت والفوسفات، وإضاعة الفرصة على الشركات الأمريكية من السيطرة عليها، كل ذلك أدى إلى إثارة المزيد من العراقيل بوجه الحكومة العراقية، لمنعها من المضي في خطواتها ، وإذا تعذر ذلك فمنع العراق من إيجابيات الاستفادة من استثمار تلك الثروات، وذلك عن طريق إيقاظ قضايا نائمة، وفتح ملفات ظلت مغلقة لزمن طويل، وفي المقدمة منها ملف التمرد الكردي في شمال العراق.
لقد عزز العراق من ثقله في الجبهة الشرقية، واتخذ موقفا متشددا من الحلول السياسية المطروحة لقضية الصراع العربي الصهيوني، وربما كانت هذه النقطة من النقاط التي أحس فيها الغرب أن العراق يتقرب أكثر مما ينبغي من حصونه الخاصة، وإزاء كل ذلك ولعدم وجود فرصة حقيقية للعراق للاستفادة من التكنولوجيا الغربية، فقد يمم وجهه نحو الكتلة الشرقية ككل، والاتحاد السوفيتي على وجه الخصوص، في بناء المشاريع الاستراتيجية في مجالات الصناعة والتعدين، كما أن توجه العراق نحو الاتحاد السوفيتي لتقوية بنيته الدفاعية كان خيارا سليما،
لأن الغرب الذي يناصب القضايا العربية العداء من غير المتوقع أن يدعم البنية الدفاعية لأي بلد عربي، كما أن العراق التزم موقفا متطابقا مع النهج الذي سار عليه منذ 14 تموز 1958م باعتماد التسليح من الكتلة الشرقية أساسا لقواته المسلحة، وأثارت هذه السياسة ردود فعل إيرانية وغربية غاضبة، لأن هذه القوى كانت تريد إبقاء العراق أسيرا للإرادات الخارجية التي كان حزب البعث العربي الاشتراكي ينظر إليها بحساسية عالية، ويرفضها رفضا مطلقا، فلا أحد أقدر من العراق كي يكون في الموضع الذي يرفض فرض شروطه عليه.
أمام هذه المستجدات على وضع العراق الداخلي وعلاقاته العربية والإقليمية والدولية بدأ التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية العراقية، يأخذ شكلا متصاعدا سياسيا وأمنيا، وكذلك بإثارة النعرات الطائفية، ونتيجة التوتر في علاقات البلدين أقدمت الحكومة الإيرانية على إلغاء معاهدة عام 1937م من طرف واحد وسارت علاقات البلدين باتجاه مزيد من التوتر والتأزم، ولم تكد تمضي سنة وستة شهور على قيام ثورة 17 تموز 1968م، إلا وكانت إيران تنفذ واحدة من أخطر مؤامراتها لقلب نظام الحكم في العراق، والتي تم احباطها في ليلة 20 على 21 كانون الثاني 1970م، وهي الخطة التي أطلق عليها اسم مؤامرة الراوي والدركزلي،
ويبدو أن فشل الخطة الانقلابية قد انعكس سلبا على سلوك الحكومة الإيرانية، التي بدت ردود فعلها غاضبة إلى أبعد الحدود، وكان طبيعيا أن يتخذ العراق موقفا سياسيا صلبا تجاه إيران، واندلعت حرب إعلامية شاملة بين البلدين، وشهدت بعض المناطق الحدودية تصعيدا عسكريا، وتم تسجيل أكثر من اشتباك بين المخافر الحدودية للبلدين،
ولكن تلك الاشتباكات لم تتطور إلى معارك كبيرة، ولم تمتد على جانبي الحدود نتيجة حسابات دولية بالدرجة الاساس والتي كان شاه إيران قوتها الرئيسة في المنطقة، فالحرب الباردة كانت في ذروتها، كما أن الاتحاد السوفيتي كان يسعى بقوة لتطوير علاقاته السياسية وتوسيع مناطق نفوذه في كل مكان، مما ترك انطباعا بأنه لن يسمح لأطراف دولية محسوبة على التحالف الغربي أن تتقدم في الأقاليم المحسوبة عليه، كان العراق في بداية صعود قوته العسكرية، ولكن وجود فرقتين عسكريتين له في الأردن،
أي نحو نصف قوته البرية كان يرتب عليه التزامات مبكرة لم يكن مستعدا لها تماما، وكان شاه إيران يعتمد سياسة الاستقواء بالولايات المتحدة، فحصلت إيران نتيجة ذلك على أحدث ما كانت تنتجه مصانع السلاح الأمريكية، كما أن علاقات إيران مع إسرائيل والتنسيق الأمني معها، وخاصة في مجال المعلومات، كل هذه العوامل وغيرها، كانت تحد من قدرة العراق على مواجهة القوة العسكرية الإيرانية، ومساعي الشاه ليكون شرطيا دوليا على منطقة الخليج العربي، في تلك الظروف العراقية المعقدة التي ساهمت إيران بصناعتها، ولعوامل تتعلق بنوايا إيران القديمة، وإصرارها على عدم تطبيق بنود معاهدة 1937م، والعمل في علاقاتها الثنائية مع العراق بموجبها،
وخاصة في خرق التزاماتها التي نصت عليها المعاهدة في تنظيم الملاحة في شط العرب، شهدت حركة الملاحة في شط العرب خروقات فاضحة لسيادة العراق المنصوص عليها في اتفاقية عام 1937م.
لقد تمسك العراق منذ قيام ثورة 17 تموز، وحتى إعلان إيران في 19 نيسان 1969م، عن إلغاء معاهدة عام 1937م من طرف واحد ومن دون تشاور مع العراق، بأن وضع الحدود بين البلدين ما زال محكوما بنصوص تلك المعاهدة، مستندا إلى أن القرار الإيراني لا يستند على أساس قانوني مشروع.
أما إيران فكانت تطرح سببين لخطوتها تلك:
الأول: أن الحكومة العراقية لم تنفذ أحد تعهداتها الواردة في المعاهدة، وهو تأسيس إدارة مشتركة مع إيران لتنظيم الملاحة في شط العرب.
الثاني: أن الظروف التي تم توقيع المعاهدة فيها قد تغيرت، فالحكومة العراقية لم تكن شرعية وإنما كانت واجهة للحكم البريطاني.
اختلقت إيران الذرائع من أجل التنصل مما تفرضه عليها الاتفاقيات والمعاهدات التي توقعها مع العراق، ويبدو أن هذه خاصية تمتاز بها السياسة الإيرانية مع العراق فقط، وإذا كانت قد زعمت بأن أحد أسباب إلغاء معاهدة عام 1937م، هو عدم شرعية الحكومة العراقية التي وقعتها بسب الوصاية البريطانية عليها، فإن الحكومة الإيرانية التي تم تشكيلها بعد سقوط نظام الشاه، ومجي آية الله خميني، كررت الدافع نفسه في محاولتها التنصل من التزاماتها بمعاهدة 1975م، ولكنها هذه المرة شككت بشرعية الشاه الذي أسقطته في 11/2/1979 وهو الذي كان قد وقعها، وهذا ما سنعالجه في فصل لاحق.
إن الحديث بتغيير الظروف كسبب لنقض الالتزامات القانونية الثنائية والجماعية، لا بد أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار بل والفوضى في العلاقات والمعاهدات الموقعة بين الدول، ويجب أن تجرد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من صفتها الشخصية بصرف النظر عمن وقعها، وتلحق بالصفة الرسمية للدولة الموقعة عليها مهما تغيرت السياسات والظروف، فالتزام الدول بما تتخذه حكوماتها في أي ظرف من الظروف يعد ملزما للدول في كل الظروف حتى في حال تغير سياساتها على المستويين الداخلي والخارجي.
ظروف العراق السياسية والعسكرية وتطور الملف الكردي
عانى العراق من أزمات كثيرة منذ نشوء الدولة الحديثة فيه عام 1921م، ومن بينها بل لعل من أكثرها تعقيدا، كانت القضية الكردية، التي عانت من تصادم وجهات النظر بين الأكراد من جهة، والسلطات الرسمية في بغداد من جهة أخرى.
وانعكست آثار المعالجات المتسرعة التي طُرحت للقضية التي كانت تزداد تعقيدا مع الوقت، وانتقلت اختلافات وجهات النظر من طرفين اثنين فقط، إلى اختلافات مركبة، فمن جهة عانى الأكراد من تباين في وجهات نظرهم في كيفية الحل، ووصلت الأمور إلى حد الصدام بين توجهين، الأول يمثله الملا مصطفى البرزاني ومعه الشطر الأعظم من الأكراد، ويمثل هذا التوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي الجانب الآخر يقف تيار جلال الطالباني ومع شطر من الأكراد لا سيما في محافظة السليمانية، ولعل ما حصل في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، عندما تمكنت قوات البيشمركة الموالية للاتحاد الوطني الكردستاني، من السيطرة على مناطق محسوبة في حساب الولاء السياسي والحزبي والعشائري، على الحزب الديمقراطي الكردستاني المنافس، بما في ذلك مدينة أربيل وهي مركز منطقة الحكم الذاتي، وهذا ما دفع مسعود البرزاني، للاستنجاد بالرئيس الشهيد صدام حسين رحمه الله، والذي أرسل بقوات الحرس الجمهوري لطرد قوات جلال الطالباني منها.
وكما أن حالة من الانقسام فرضت نفسها على الأكراد، فإن العرب عانوا من حالة انقسام سياسي أيضا فيما بينهم، فالأحزاب كانت ترى في وجهات نظرها المعلبة، وغير القابلة لإعادة نظر، نتيجة تعقيدات الظروف السياسية، فالحركة السياسية كانت تُغير مواقفها مثل تغير الأنواء الجوية في العراق، أو مثل حركة الكثبان الرملية، وكانت تحتكم في ذلك إلى مواقفها المتغيرة من حزب البعث العربي الاشتراكي، وتأثرها سلبا أو ايجابا تبعا لعلاقاتها مع البعث، من دون أن تضع معيارا وطنيا لتحديد اتجاهات بوصلتها السياسية والمبدئية تجاه هذه القضية بالذات.
وتميز الحزب الشيوعي العراق، الذي “يُفترض” به أنه الوحيد الذي يحمل تصورا متكاملا لكل مشاكل العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقومية، ولكنه كان أسرع الحركات السياسية بتبديل قناعاته المعلنة، وكان ذلك انعكاسا لمواقف الدولة السوفيتية، وكأن ذلك كان يتم بأسرع من استبدال الملابس تبعا لمواسمها، فمن موقفه كشريك في الجبهة الوطنية، إلى تشكيل كتائب مسلحة تتخذ من جبال كردستان كمقار ومعسكرات لمتطوعيه، للقتال بلا قضية، أما موضع انشقاق الحزب إلى جناحي اللجنة المركزية الموالية لموسكو، والقيادة المركزية التي قيل إنها موالية للنهج الماوي، وخاصة باعتماد الكفاح المسلح لمواجهة حكم البعث، فقد كانت أحجية عقائدية غير قابلة للحل.
كما أن الحركات والأحزاب الشيعية التي بدأت بالحزب الفاطمي والذي اختار لاحقا اسما آخر وهو “حزب الدعوة”، والتي تشكل بقرار من شاه إيران وبإشراف من السافاك، وتنفيذ من بعض معممي ما يسمى بالحوزة العلمية، فقد كان مثالا صارخا على الارتباط بمشاريع دول معادية للعراق، من أجل تقوية الموقف التفاوضي لإيران وإضعاف الموقف العراقي.
وفي الجانب السني، كانت حركة الاخوان المسلمين، تمثل توجها ساذجا لا يرعى مصالح العراق في توجهاته العامة وفي بياناته المعلنة، بل كان كل همه أن يناصب البعث العداء، من دون أن يقدم رؤية ناضجة، لحل مشاكل العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في مثل هذه الظروف العراقية المعقدة، وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى الحكم بعد ثورة 17/30 تموز 1968، فتسلم ملف شائكاً للقضية الكردية تراكمت عليه عقد سياسية واجتماعية مع الوقت ومع كل اجتهاد جديد لوزارة أو حكومة جديدة.
ورأى البعث أن هذه القضية بالذات، تحتاج منه جهدا استثنائيا جادا، لإيجاد الحلول الواقعية لها، بما يؤمّن اعترافا بالحقوق الثقافية والسياسية للأكراد، من جهة وحفاظا على وحدة العراق من جهة أخرى، غير أن جهود الحزب كانت على الدوام تصطدم بأن الجانب الكردي يفتقد إلى من يمثله تمثيلا حقيقيا وكاملا ومعترفا به من قبل جميع الأطراف الأخرى، فحينما بدأت الحكومة اتصالاتها مع الحزب الديمقراطي (جناح إبراهيم أحمد وجلال الطالباني) بعد الثورة مباشرة، كان الملا مصطفى البرزاني يصدر أوامره للبيشمركة لبدء القتال ضد القوات العراقية، فيما اعتبر البرزاني الطرف الذي اتفق مع الحكومة خونة للشعب الكردي، وأطلق لقب (الجحوش) على المنشقين عن حزبه،
وعلى كل من يتعاون مع الحكومة، ولم تكتف حركة الملا مصطفى بإعلان الحركات العسكرية في المنطقة الكردية، بل نقلت عملياتها الارهابية إلى بغداد وعدة مدن عراقية أخرى، إذ حصلت تفجيرات في الساحات العامة وعلى مقربة من مقرات الدوائر الحكومية الحساسة، في رسالة واضحة المعالم للحكومة، بأن تلك الحركة قادرة على نقل المعركة إلى قلب العاصمة، وأنها وحدها التي تحدد مكان الضربة وتوقيتها، إلا أن هذا لم يمنع الحكومة من البحث عن مداخل جديدة، لحلول ناجحة تؤمّن للشعب الكردي حقوقه المشروعة ضمن الدولة العراقية الواحدة وتضمن للعراق استقراره والمضي في خطط التنمية.
ولأن الحكومة حددت برنامجا اقتصاديا طموحا، وواضح المعالم في التعامل مع الملف النفطي، وتفعيل قانون رقم 80 لسنة 1961م، وبعثت الحياة في شركة النفط الوطنية العراقية، التي ظلت كيانا على الورق، ولم تتحول إلى مؤسسة تعمل في الميدان المخصص لها، والذي كان يعد تحديا جديا لسلطة الشركات النفطية، وكذلك توقيع اتفاقية للتعاون بين العراق والاتحاد السوفيتي، لاستثمار حقل الرميلة الشمالي، الذي تنظر إليه تلك الشركات على أنه حق ثابت لها، سلبته منها الحكومة العراقية بموجب قانون رقم 80، ولكن الحكومة لم تحوله إلى تطبيق على الأرض لحوالي عشر سنين، ونظرت الشركات إلى الاتفاقية مع الجانب السوفيتي، على أنها بداية التحرك عمليا لتطبيق القانون المذكور، على أهم حقل نفطي خسرته الشركات، فقد كان ذلك إيذانا ببدء مرحلة جديدة من المواجهة بين الطرفين.
لقد استثارت هذه السياسة حالة من العداء ضد العراق، دفعت نحوها الدول المالكة لشركات النفط العاملة في العراق، ولعبت تلك الشركات ومن ورائها بريطانيا والدول الغربية الأخرى، دور المحرض لشاه إيران والحركة الكردية، في محاولة منها لتشديد الضغوط على الحكومة العراقية، ومنعها من المضي في برامجها السياسية والاقتصادية، واشتدت المضايقات السياسية والاقتصادية والأمنية على حكومة حزب البعث، ظنا من أعدائه أن تشديد الضغوط المختلفة سيؤدي إلى تشتيت قواه لمواجهة مشكلات مزمنة ومستحدثة على مساحة أوسع، وقد لا يستطيع تحديد الأولويات السليمة لمعالجة أزمات البلد، ومع ذلك فقد واصل العراق نهجه السياسي وبرنامجه الاقتصادي بعزم وإصرار لم تنجح محاولات الحلف المعادي في تعطيل مسيرته أو وقف خطوات البناء الاقتصادي،
وخاصة في الاستثمار الوطني المباشر للنفط والكبريت والفوسفات، وبمعونة اقتصادية فنية خارجية لا تؤثر سلبا على استقلال العراق الوطني في هذا المجال.
في هذا الوقت كانت القيادة قد شكلت فرق عمل من قيادات حزبية وإدارية، وبدأت الاتصالات السرية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة الملا مصطفى البرزاني، وبدأت تلك الاتصالات تعطي نتائج ملموسة وإن كانت بطيئة، وتم التوصل إلى توقيع بيان 11 آذار 1970، والذي قيل في حينه إنه سيسهم في وضع حد نهائي لهذه المشكلة التي استنزفت العراق بشريا وماديا وأخرت مسيرته في البناء الاقتصادي والعمراني، وحولته إلى ساحة تدخلات لقوى خارجية لها أجنداتها في حضور عسكري في المنطقة، ولم تفكر يوما بمصلحة الأكراد ولا العرب، عندما كانت تمد يد العون لهذا الطرف أو ذاك.
ومن بين النقاط التي تم التوصل إليها بين طرفي الحوار السياسي، منح المنطقة الكردية، حكما ذاتيا في غضون أربع سنوات من يوم صدور بيان 11 آذار 1970، لكن رفض الحركة الكردية لترتيبات إعلان قانون الحكم الذاتي في موعده المحدد، وسحب الوزراء الأكراد من الحكومة، أعاد القضية إلى المربع الأول من التأزم، بل واشتعلت المنطقة بحركات عسكرية واسعة النطاق، ربما لم تشهدها طيلة تاريخها، ولا يمكن أن نحصر الأسباب في طرف واحد، ولكن إيران التي رأت في منح أكراد العراق حقوقا سياسية ثقافية وإدارية، تهديدا لأمنها الوطني ووحدة أراضيها، رأت أن الطريق الوحيد لإفشال هذا المشروع، هو في ارتداء لباس الحرص على الأكراد، والمزايدة على العراق في هذا المجال،
فبدأت بالتدخل بكل ما لديها من خبث ووسائل، لإثارة الاضطراب في شمال العراق، وبالفعل بدأت الأسلحة تتدفق على الحركة الكردية ومن كل المناشئ والعيارات عبر الأراضي الإيرانية، ونجحت إيران في إدخال إسرائيل التي تحمل موروثا من المخاوف التلمودية من دور العراق في القضاء على “دولة إسرائيل” على الخط، كما تدخلت الولايات المتحدة بثقل استثنائي في دعم الحركة الكردية، لمجرد إشغال العراق بحزام أزمات متعددة، وزودت الحركة بأسلحة الدفاع الجوي، بما في ذلك صواريخ هوك.
لم يكن هدف إيران في أي يوم من الأيام الانتصاف لأكراد العراق، ولم تقف إيران في أي وقت لتدافع عن قضية أو دين أو مذهب، وكانت قياداتها بصرف النظر عن اللافتة التي تقف تحتها، تتبنى مشروعا إيرانيا توسعيا، له أهدافه الخاصة في أكثر من محور وساحة، لا سيما في العراق والخليج العربي، وتسعى لسلب الإطلالة البحرية من العراق وبخاصة في شط العرب، فبدأت تبعث برسائل إلى الحكومة العراقية عبر وسطاء من جنسيات مختلفة، بأنها على استعداد لوقف دعمها للحركة الكردية في حال موافقة العراق على توقيع اتفاقية حدود جديدة بين البلدين، ترسم مسارا جديدا للحدود في شط العرب، وبمقابل إعادة بعض المناطق الحدودية التي كانت قد استولت عليها في ظروف سابقة.
وبعد سلسلة من الاتصالات التي أجراها الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين رحمه الله، بين البلدين، ونتيجة عدم ايفاء الاتحاد السوفيتي بالتزاماته في توفير الدعم للعراق، اضطرت القيادة لإبرام اتفاقية الجزائر لعام 1975، وقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة في ذلك الوقت السيد صدام حسين رحمه الله، ووقعها عن الجانب الإيراني شاه إيران محمد رضا بهلوي، وتم ذلك خلال انعقاد قمة دول الأوبك في العاصمة الجزائرية.